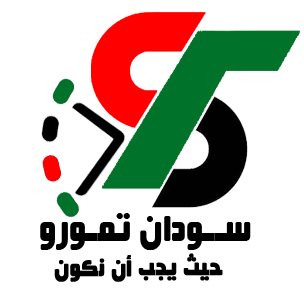سودان تمورو:
لم يكن تعثّر السودان في استعادة مقعده داخل الاتحاد الأفريقي مجرد تفصيل دبلوماسي عابر في دفتر العلاقات الخارجية، ولا نتيجة مباشرة لتحركات هذا التحالف أو ذاك، بل كان انعكاساً مكثفاً لأزمة شرعية تضرب في عمق الدولة السودانية نفسها. فمنذ تجميد عضوية الخرطوم عقب إنقلاب أكتوبر 2021، ظل السؤال يتردد بإلحاح.. لماذا استعصت الأبواب الأفريقية رغم تبدّل الوجوه وتكاثر الوساطات؟ وهل حقاً – كما روّجت بعض المنابر، وفي مقدمتها سكاي نيوز عربية – أن تحركات “تحالف صمود” بقيادة عبد الله حمدوك كانت حجر العثرة أمام عودة السودان إلى مقعده؟.
القول بذلك يختزل أزمة مركبة في خصومة أشخاص. فقرار الاتحاد الأفريقي لم يكن رهين موقف فصيل سوداني بعينه، بل كان صدى لمعادلة قارية أوسع تحكمها غريزة بقاء الأنظمة. القارة التي عانت من أكثر من مئتي محاولة انقلاب عسكري، ما بين ناجحة وفاشلة، طوّرت حساسية مفرطة تجاه أي سابقة قد تُقرأ كشرعنة للأمر الواقع العسكري. إعادة السودان في ظل وضع نتج عن تحرك عسكري – حتى لو أُحيط بواجهة مدنية أنيقة – كانت ستُفهم كرسالة خاطئة إلى جيوش أخرى مفادها أن الطريق إلى السلطة يمكن أن يُعبّد بالدبابات ثم يُعترف به بالصبر الدبلوماسي. من هنا، بدا تعليق العضوية قراراً وقائياً لحماية العواصم الأفريقية من “عدوى الخرطوم”، أكثر من كونه انتصاراً أخلاقياً لمبادئ الديمقراطية.
في هذا الإطار يمكن فهم حدود الجهد الذي بذلته مصر، الحليف التقليدي للمؤسسة العسكرية السودانية، داخل أروقة مجلس السلم والأمن. القاهرة سعت إلى تليين الموقف القاري، انطلاقاً من اعتبارات أمنية وجيوسياسية تتعلق باستقرار وادي النيل، غير أن هذا المسعى اصطدم بجدار التوجس الجماعي لدى دول أفريقية تخشى أن يُقرأ أي تساهل مع الخرطوم كسابقة قابلة للاستنساخ داخلياً. حتى الدول المتعاطفة مع الجيش السوداني لم تكن مستعدة لتحمل كلفة سياسية تفتح عليها أبواب الشكوك في عواصمها. وهكذا ظل هاجس “منع العدوى” أقوى من اعتبارات التضامن أو الاصطفاف الإقليمي.
ومع انسداد الأفق الأفريقي منذ 2021، لجأت السلطة في الخرطوم إلى ورقة “الواجهة المدنية”، فدُفع باسم كامل إدريس، مستندة إلى سيرته الدولية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، على أمل أن يمنح ذلك انطباعاً مختلفاً في العواصم الغربية ويخفف من التحفظات الأفريقية. بدا الرهان واضحاً.. استدعاء نموذج تكنوقراطي يشبه من حيث الخلفية المهنية تجربة عبد الله حمدوك، علّه يعيد إنتاج لحظة القبول الدولي. غير أن هذا الرهان كشف خللاً أعمق في قراءة طبيعة النظام الدولي. فالغرب لا يتعامل بمنطق “الوجه المقبول” بل بمنطق “المصلحة المضمونة”. لا تعنيه كثيراً خلفية الحاكم بقدر ما تعنيه قدرته على ضمان المصالح الغربية بما يخدم التوازنات الاستراتيجية. تغيير القشرة المدنية دون تعديل جوهر السلطة لم يكن كافياً لإقناع الخارج بأن شيئاً بنيوياً قد تبدّل.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى قراءة تجربة عبد الله حمدوك نفسها بعيداً عن ثنائية التقديس والشيطنة. الرجل نجح في إعادة السودان إلى الحظيرة الدولية بعد عقود من العزلة، وفتح قنوات مع المؤسسات المالية، ورفع اسم البلاد من قوائم العقوبات. غير أن حكومته وقعت في فخ التعويل المفرط على الدعم الخارجي، فيما ظل الداخل هشاً، والاقتصاد مثقلاً، والتحالفات السياسية رخوة. لم تُبنَ كتلة اجتماعية منظمة تحمي الانتقال، ولم يُنجز إصلاح عميق في بنية الدولة الأمنية والاقتصادية. وعندما وقع الانقلاب، تبيّن أن الشرعية الدولية وحدها لا تكفي إذا لم تسندها قوة داخلية متماسكة.
اليوم يجد “تحالف صمود” نفسه في معادلة أشد تعقيداً. فهو يرفض الانخراط في شراكة تمنحه دور التابع مع الجيش، وفي الوقت ذاته لا يستطيع الاصطفاف مع قوات الدعم السريع التي ارتبط اسمها – في وعي قطاعات واسعة من السودانيين – بانتهاكات جسيمة وفوضى مسلحة. هذا الوقوف في المنطقة الوسطى مفهوم أخلاقياً، لكنه سياسياً محفوف بالمخاطر، لأن السياسة لا تحتمل الفراغ طويلاً، ولأن قوتين مسلحتين تتصارعان على الأرض لا تعترفان عادة بشراكة متكافئة مع قوة مدنية غير مسنودة برافعة تنظيمية صلبة.
ولفهم عمق المأزق لا بد من العودة إلى لحظة 2019. آنذاك انقسمت القوى المدنية بين رؤية الصادق المهدي التي دعت إلى التوافق المرحلي مع العسكر باعتبارهم قوة لا يمكن تجاوزها دفعة واحدة، ورؤية محمود حسنين التي حذّرت من أن الشراكة ستقوّض الثورة من الداخل. اختارت قوى الحرية والتغيير طريق الشراكة حقناً للدماء، لكن إدارة المرحلة شابها تنافس حزبي ضيق، وخطاب متوتر، ومحاولات إقصاء متبادل أضعفت الجبهة المدنية تدريجياً. تحولت الثورة من مشروع جامع إلى ساحة صراع على التمثيل، فانكمشت الكتلة المدنية وتراجعت قدرتها التفاوضية.
وفي قلب هذا الانقسام برزت معضلة الإسلاميين، وعلى رأسهم حزب المؤتمر الوطني. المنطق الثوري يبرر إقصاء من ارتبط اسمه بالفساد والاستبداد، لكن منطق السياسة يقول إن القوى ذات الامتداد التنظيمي والاجتماعي لا تختفي بقرار إداري. إقصاؤها الكامل من المجال السياسي، دون صيغة عدالة انتقالية متوازنة تجمع بين المحاسبة والإدماج، قد يدفعها إلى العمل من خارج النظام بوسائل معطِّلة. السؤال لم يكن يوماً هل يُحاسَب المسؤولون عن الانتهاكات؟ بل كيف تُبنى معادلة انتقالية لا تتحول فيها المحاسبة إلى أداة صراع صفري يعمّق الانقسام ويُضعف الدولة.
كل ذلك يعيدنا إلى جوهر الأزمة.. المشكلة ليست في الأسماء، سواء كان حمدوك أو كامل إدريس، بل في البنية التي يعملان داخلها. دولة لم يُحسم فيها بعد سؤال العلاقة بين المدني والعسكري، ولم يتشكل فيها عقد اجتماعي جامع، ستظل رهينة توازنات قسرية وهشة. وفي ظل هيمنة السلاح على السياسة، يصبح أي تغيير في الواجهة أقرب إلى إعادة ترتيب المقاعد على متن سفينة تتلاطمها الأمواج.
من هنا فإن الرؤية المستقبلية لا ينبغي أن تبدأ من سؤال “متى نعود إلى مقعدنا في أديس أبابا؟”، بل من سؤال أعمق.. كيف نؤسس لشرعية داخلية مستقرة؟ استعادة المقعد في الاتحاد الأفريقي ستكون نتيجة طبيعية لأي توافق وطني حقيقي، لا هدفاً قائماً بذاته. العلة ليست في مقر المنظمة، بل في بنية السلطة في الخرطوم. الطريق إلى أديس أبابا يمر أولاً عبر إعادة بناء الدولة على إيقاف الحرب وبناء أسس مدنية متوافق عليها، وعبر توحيد الصف المدني، وتجاوز عقلية المحاصصة، وصياغة خطاب سياسي يخاطب كل مكونات المجتمع دون استعلاء أو إقصاء.
السودان يقف اليوم بين مقعد شاغر في أديس أبابا وكرسي مشتعل في الخرطوم. والمقعد لن يُستعاد بتبديل الوجوه أو تصعيد الخطاب الإعلامي، بل ببناء قوة مدنية قادرة على تحويل شرعية الثورة إلى مؤسسات حكم، وعلى مخاطبة الخصوم بلغة السياسة لا بلغة التخوين. تلك هي المعادلة الصعبة.. أن تبقى وفياً لمبادئ الثورة، وأن تتقن في الوقت ذاته فن الممكن، حتى لا يتحول الحلم بالتغيير إلى حلقة أخرى في مسلسل المآزق السودانية المفتوحة.