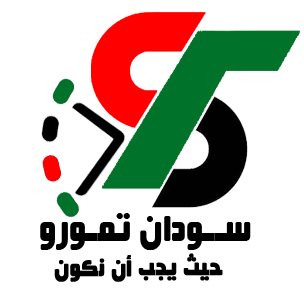سودان تمورو
عندما كُشفت تفاصيل شبكة جيفري إبستين، بدا الأمر في البداية كفضيحة جنسية ضخمة لرجل ثري يملك جزيرة خاصة ويستضيف فيها سياسيين ورجال أعمال وعلماء ومشاهير. لكن مع توسع التحقيقات وتسريب الوثائق، تحوّلت القضية من ملف جنائي إلى سؤال أكبر: كيف وصل هذا الرجل إلى هذا العدد من أصحاب القرار؟
واللافت في الأمر، إلى جانب الجرائم المرتكبة، هوية الأشخاص الذين كانوا جزءاً من هذا العالم: رؤساء دول، وزراء، مليارديرات، شخصيات أمنية، وعلماء مؤثرون في مجالات حساسة.
شبكة نفوذ خارج المنطق الاقتصادي
إحدى النقاط المشتركة في التقارير حول جيفري إبستين هي حجم شبكة علاقاته. لم يكن رجل أعمال تقليدياً، ولا صاحب شركة عملاقة تبرر ثروته وعلاقاته، ومع ذلك استطاع الوصول إلى رؤساء دول وأمراء ومليارديرات وقادة شركات تكنولوجية ومؤسسات علمية حساسة. هذا النوع من الشبكات يثير دائماً تساؤلات في عالم الاستخبارات، لأن الشخص القادر على جمع هذا العدد من أصحاب النفوذ في بيئة خاصة يصبح تلقائياً نقطة اهتمام لأي جهاز أمني.
ولعلّ شريكته غيلين ماكسويل، تعدّ أبرز الخيوط التي تغذي الشبهات حول علاقة إبستين بالاستخبارات. والدها، روبرت ماكسويل الذي كان أحد أقطاب الإعلام عالمياً ونائباً في البرلمان البريطاني، وأحاطت به شبهات علاقات مع الاستخبارات البريطانية و”الموساد” ودوائر سوفياتية خلال الحرب الباردة.
انتهت حياة روبرت ماكسويل عام 1991 بعد سقوطه من يخته في ظروف غامضة، وتعددت الروايات بين انتحار وحادث وتصفية، من دون حسم نهائي، وبقي ماكسويل حاضراً في تقاطعات حساسة بين المال والإعلام والاستخبارات.
بعد سنوات، ظهرت ابنته غيلين في قلب شبكة إبستين، كحلقة وصل بينه وبين عدد كبير من شخصيات النخبة التي ارتبط بها والدها.
رجل أعمال أم “أصل” استخباري؟
أمام تشابك شبكة علاقات جيفري إبستين، وغياب أي تفسير اقتصادي أو مهني واضح يبرّر مكانته ونفوذه، تتصاعد الشكوك حول احتمال ارتباطه بأجهزة استخبارية. وقد عزّزت هذه الشكوك تقارير حديثة ظهرت في الأيام الماضية، تحدثت عن نشاطات لإبستين على صلة بوكالات استخبارات أجنبية.
قد لا يكون إبستين ضابطاً أو عميلاً رسمياً، بل ما يُعرف في الأدبيات الاستخبارية بـ”الأصل”، أي شخص مفيد تملك الأجهزة القدرة على الاستفادة من شبكته وعلاقاته من دون أن يكون موظفاً لديها. وهذا التقدير طرحته مسؤولة بريطانية رفيعة في الأمن القومي، التي أشارت إلى أن احتمال كونه “أصلًا” ممكن.
أو قد يكون هناك سيناريو آخر، إذ إن إبستين لم يبدأ كأداة استخبارية، بل كرجل أعمال غامض كوّن شبكة علاقات بنفسه، ثم تحوّل لاحقاً إلى هدف أو فرصة للأجهزة. وفي هذا السياق، أظهرت وثائق كشفتها صحيفة “واشنطن بوست”، أن محامي إبستين طلب سجلات من وكالة الاستخبارات المركزية، بحثاً عن أي علاقة محتملة بينه وبين الوكالة.
وبالفعل، كان ردّ الـ”CIA” لافتاً، إذ نفت وجود أي انتساب علني له، لكنّها استخدمت الصيغة الاستخبارية المعروفة، قائلةً إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي وجود علاقة سرية. هذه العبارة لا تثبت شيئاً، لكنها تترك الباب مفتوحاً لكل الاحتمالات.
وأشارت رسالة الرفض المؤرخة في 30 يوليو 2014 إلى أن “دارين ك. إنديكي”، محامي إبستين، كان يبحث عن “سجلات، ووثائق، وملفات، ومراسلات، ومذكرات، وأوامر، واتفاقيات، و/أو تعليمات تتعلق أو تشير إلى السيد إبستين” لفترة تمتد لـ 14 عاماً تقريباً حتى مطلع عام 2014.
كما كشفت الوثائق أن إبستين التقى وتبادل رسائل مع ويليام بيرنز، الذي أصبح لاحقاً مدير وكالة الاستخبارات المركزية. ولم تُوجَّه أي اتهامات لبيرنز، وقد قال إنه لم يكن يعرف شيئاً عن جرائم إبستين، لكن مجرد وجود هذه اللقاءات يوضح مستوى الدوائر التي كان إبستين يتحرك داخلها.
“الإسرائيليون استغلوا مواهب إبستين”
أشار ضابط المخابرات الإسرائيلية السابق، آري بن ميناشي، مؤلف كتاب “أرباح الحرب: داخل شبكة الأسلحة الأميركية-الإسرائيلية السرية”، والذي كان له دور في إفشاء العديد من القضايا، في مقابلة شهيرة مع أفشان راتانسي، إلى أنّ “الإسرائيليين استغلوا مواهب إبستين وحوّلوه إلى عميل، وأن الإدارة الأميركية واقعة في المصيدة الإسرائيلية، ويصعب عليها الفكاك منها”.
الوثائق كشفت أيضاً تمويل إبستين لمنظمة “أصدقاء قوات الدفاع الإسرائيلية” (FIDF)، التي تصف نفسها بأنها “منظمة رسمية” مخوّلة لجمع التبرعات الخيرية نيابة عن جنود “الجيش” الإسرائيلي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بـ25,000$، بالإضافة إلى منظمة بناء المستوطنات “الصندوق الوطني اليهودي” (JNF) بـ15,000$
كما زعم مُخبر سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI”، وفق صحيفة “التايمز” البريطانية، بأن إبستين، بدلًا من أن يكون مُعادياً لـ “إسرائيل”، كان في الواقع يعمل لصالح جهاز التجسس الإسرائيلي (الموساد). وذكر تقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس، بتاريخ تشرين الأول/أكتوبر 2020، أن مصدر المكتب “اقتنع بأن إبستين كان عميلًا مُجندًا للموساد”.
وكان ديباك شوبرا، الخبير الروحي الأميركي من أصل هندي ومؤلف كتب الصحة الشهير، مُسهباً في مدح “إسرائيل”، تماماً كما كان مُتحمساً لانضمام جيفري إبستين إليه في “تل أبيب”.
قبل عامين من اعتقاله عام 2019، دُعي إبستين للقاء شوبرا عندما كان في “إسرائيل” لإلقاء محاضرة في قاعة مينورا في “تل أبيب”. وكتب شوبرا: “تعال إلى إسرائيل معنا. استرخِ واستمتع بصحبة أناسٍ مميزين. إذا أردت، استخدم اسماً مستعاراً. أحضر فتياتك. سيكون من دواعي سرورنا وجودك. مع حبي”.
نموذج “كينكورا”: عندما تتحوّل الجريمة إلى أداة ابتزاز
في كل الدول، يُفترض أن تُتخذ القرارات السياسية والعسكرية بناءً على المصالح الوطنية والتوازنات والاعتبارات الاستراتيجية. لكن التاريخ الاستخباري يقدّم أحيانًا صورة مختلفة تماماً عن قرارات لا تُصنع في غرف العمليات ولا على طاولات الحكومات، بل في غرف مغلقة، وأحيانًا في أماكن أكثر ظلمة، حيث تتحول الأسرار الشخصية إلى أدوات ضغط.
“كينكورا”، الدار التي كانت مخصصة لرعاية فتيان قاصرين خلال سبعينيات القرن الماضي، تحولت بحسب التحقيقات اللاحقة إلى مكان تُرتكب فيه اعتداءات جنسية ممنهجة. عندما كُشفت الفضيحة، أُدين عدد من المسؤولين عن الدار بجرائم الاعتداء على الأطفال. لكن القضية لم تنتهِ عند هذا الحد، إذ ظهرت لاحقًا اتهامات بأن أجهزة أمنية بريطانية كانت على علم بما يجري، أو على الأقل غضّت الطرف عنه، لاستخدام هذه الجرائم في ابتزاز شخصيات وحدوية نافذة في أيرلندا الشمالية خلال فترة “الاضطرابات”.
القاسم المشترك بين قصص مثل شبكة جيفري إبستين أو فضيحة “دار كينكورا”، ليس فقط الجانب الإجرامي أو الأخلاقي، بل فكرة الابتزاز كأداة سلطة. ففي هذه الحالات، قد لا يكون الهدف المال أو المتعة، بل التحكم بقرارات أشخاص في مواقع حساسة، وتحويل نقاط ضعفهم الشخصية إلى مفاتيح نفوذ سياسي.
الابتزاز الجنسي: حين تُدار الدول من غرف النوم
في الظاهر، تبدو الدول محكومة بدساتير ومؤسسات وانتخابات. لكن تحت هذا السطح، يعمل منطق آخر أكثر بساطة وخطورة: من يملك السر، يملك القرار.
يبدأ الابتزاز الجنسي، بشخص في موقع مسؤولية يرتكب فعلاً يمكن أن يدمّر حياته السياسية أو الاجتماعية إذا كُشف. لاحقًا، تحصل جهة ما على دليل يوثق هذا الفعل، سواء عبر تسجيل أو شهادة أو صورة. من تلك اللحظة، لا يعود هذا الشخص مجرد فرد ارتكب خطأً، بل يتحول إلى مصدر معلومات، أو قناة نفوذ، أو أداة لتمرير قرارات بعينها. وهكذا يصبح القرار ناتجاً عن خوف شخصي من الفضيحة لا عن اقتناع أو مصلحة وطنية.
وفي أدبيات الاستخبارات، هذا الأسلوب معروف منذ عقود باسم “مصيدة العسل” أو “Honey Trap”، الذي يقوم على استدراج شخصيات حساسة إلى علاقات يمكن توثيقها، ثم استخدام هذه المواد للضغط لاحقاً. وهي بالفعل استُخدمت تاريخياً ضد سياسيين ورجال أعمال وضباط ودبلوماسيين.
يكفي أن يكون في كل موقع حساس شخص واحد خائف من فضيحة. عندها يمكن التأثير على تصويت في البرلمان، أو تمرير صفقة سلاح، أو تعديل قرار أمني، أو تغيير موقف سياسي، أو حتى القيام بحرب. هكذا يتحول القرار السياسي من تعبير عن إرادة الدولة إلى رد فعل شخصي لإنقاذ سمعة مسؤول.
على سبيل المثال، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كانت له علاقة اجتماعية بإبستين منذ أواخر الثمانينيات، وظهر معه في مناسبات عدة، كما ورد اسمه 4837 في الوثائق التي نُشرت. كما ذُكر اسم الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون في سجلات الرحلات والتقارير المرتبطة بإبستين.
أما الحالة الأكثر حساسية سياسياً فكانت للأمير أندرو، الذي واجه اتهامات مباشرة من إحدى ضحايا إبستين بإقامة علاقة معها عندما كانت قاصراً. ورغم نفيه ذلك، أدت الضغوط إلى تجريده من ألقابه الملكية الرسمية. إلى جانب هؤلاء، ظهرت أسماء سياسيين ودبلوماسيين آخرين في الوثائق.
إبستين وجزيرته قد يكونان جزءاً من لعبة أكبر، فمن استقدم “النخب” إلى الجزيرة وصوّرهم، ليس بعيداً أن يكون قد امتلك القدرة على ابتزاز بعضهم، سواء لحسابه أو لحساب جهات أخرى. عندها، تصبح القرارات السياسية رهن الشبكات المغلقة والأسرار الشخصية، في ظل قوة خفية تمارس نفوذها بصمت. فكم من قرارات اتُخذت في السنوات الماضية من ملفات مخبأة في أدراج مغلقة؟
تاريخ إبستين هو الوجه الحقيقي للغرب، الذي يبرر حروبه وتدخّلاته في بلادنا تحت عنوان “إرساء الأخلاق والحقوق والديمقراطية”. لكن النخب نفسها التي تعظ العالم عن القيم، ظهرت داخل عالم من الابتزاز والاعتداءات والأفعال القذرة. لهذا إبستين لم يكن استثناءً، بل كان المرآة التي عكست ما يجري خلف خطاب “القيم” الذي يتم تصديره.