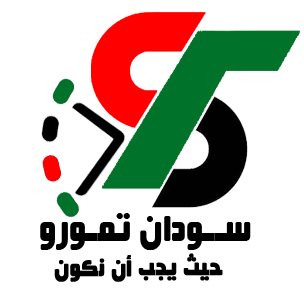سودان تمورو:
في الفراغ الذي خلفه غياب مؤسسات الدولة في السودان، برزت قوى محلية تتولى مهام الأمن بصورة غير رسمية، من لجان حراسة شعبية إلى مجموعات مسلحة ذات نفوذ داخل الأحياء. هذه الكيانات، التي نشأت بدافع الحماية في ظاهرها، تحولت مع الوقت إلى سلطات أمر واقع، تفرض قواعدها الخاصة، وتعيد تعريف الأمن خارج إطار القانون.
أحد أعضاء لجان الحراسة يقول “نحن لسنا مخولين بتنفيذ القانون، ولا نستطيع الانسحاب وترك الناس لمصيرهم. لذا فإن أي خطأ قد يحولنا من حماة إلى متهمين، وأي تهاون قد يعرض الحي للفوضى”.
منذ اندلاع حرب السودان في منتصف أبريل (نيسان) 2023، لم تقتصر تداعيات الفوضى على ساحات القتال، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية، وتحولت الجريمة إلى نشاط منظم في ظل الغياب شبه الكامل للشرطة وأجهزة إنفاذ القانون، حيث تستهدف شبكات السرقة المنازل والأسواق في وضح النهار، بينما يلجأ المواطنون إلى “العدالة الشعبية” أو “الأمن الذاتي” كبديل اضطراري للحماية.
وبين انهيار المؤسسات وتصاعد الخوف بفعل انتشار الجريمة، يعاد تشكيل مفهوم الأمن خارج إطار الدولة، في مشهد يكشف كيف تدار الجريمة لا بوصفها انفلاتاً عابراً، بل كأحد إفرازات الحرب وانكسار سلطة القانون.
تفكك واضح
لم يكن غياب الشرطة في السودان حدثاً مفاجئاً بقدر ما كان نتيجة تراكمية لانهيار الدولة تحت وطأة الحرب، ومع تفكك سلاسل القيادة وتوقف عمل أقسام الشرطة والمحاكم، نشأ فراغ أمني واسع لم يترك الشارع بلا سلطة فحسب، بل أعاد رسم خريطة السيطرة داخل الأحياء والأسواق، حيث جعل هذا الفراغ الجريمة نشاطاً منظماً تحكمه المعرفة المسبقة، وتغذيه هشاشة الواقع وانعدام الردع.
المتخصص الأمني محمد المصطفى قال، “ما يجري في السودان اليوم يتجاوز توصيفه كانفلات أمني عابر، فنحن أمام تفكك شبه كامل لمنظومة الأمن العام، وهو تفكك بدأ تدريجاً ثم تسارع مع اندلاع الحرب. فالشرطة، بوصفها الواجهة اليومية للدولة، كانت أول من غاب عن المشهد، إما بسبب الاستهداف المباشر، أو انهيار سلاسل القيادة، أو انعدام القدرة اللوجيستية على العمل. هذا الغياب بعث رسالة واضحة مفادها بأن القانون لم يعد حاضراً في الشارع”.
وتابع المصطفى، “في مثل هذه الظروف لا تختفي الجريمة، بل تعيد إنتاج نفسها بصورة أكثر تنظيماً. فالسرقات التي نشهدها حالياً ليست عشوائية، بل تقوم على الرصد المسبق وجمع المعلومات ومعرفة طبيعة الأحياء ومن غادرها ومن بقي فيها. بعض هذه الشبكات تعمل منذ ما قبل الحرب، لكنها وجدت في الفوضى فرصة ذهبية للتوسع، مستفيدة من غياب البلاغات وتعطل التحقيقات وعدم وجود جهة قادرة على المتابعة أو الردع”.
وواصل، “الأخطر من ذلك أن الجريمة بدأت تتحول إلى نشاط شبه اقتصادي له قنوات تصريف واضحة وأسواق لبيع المسروقات وأشخاص معروفين داخل المجتمعات المحلية، لكن لا أحد يملك الجرأة أو الوسيلة لمحاسبتهم. فالمواطن العادي أصبح الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، إذ لا يملك سلاح الدولة ولا حماية القانون، وفي الوقت ذاته يواجه عنفاً منظماً”.
واستطرد، “هذا الواقع دفع كثيرين إلى اللجوء لما يعرف بالعدالة الشعبية، وهي في حقيقتها تعبير عن اليأس أكثر مما هي رغبة في الانتقام. فالناس لا تثق في أن الجاني سيحاسب عبر القنوات الرسمية فتأخذ العدالة بيدها، مما يفتح الباب لانتهاكات جسيمة ولتصفية حسابات وأحياناً لمعاقبة أبرياء. وهنا يدخل المجتمع في دائرة خطرة، حيث يتحول إلى ساحة صراع مفتوح بلا ضوابط ولا معايير”.
وأردف المتخصص الأمني “من وجهة نظر أمنية، لا يمكن كسر هذه الحلقة من دون استعادة الحد الأدنى من حضور الدولة. فالحديث عن زيادة الدوريات أو تشكيل لجان أهلية لن يكون كافياً إذا لم تستعد الثقة في القانون كمظلة جامعة. فالأمن ليس مجرد قوة، بل علاقة بين الدولة والمجتمع، وحين تنكسر هذه العلاقة تدار الجريمة كواقع يومي لا كاستثناء”.
سرقات منظمة
في ظل الحرب وانهيار منظومات الرقابة، تحولت السرقات إلى نشاط منظم تحكمه شبكات لها أساليبها ومساراتها، ونشأ اقتصاد ظل قائماً على النهب وإعادة البيع، مستفيداً من غياب الدولة وتفكك المجتمع وتآكل الخوف من العقاب. هكذا انتقلت الجريمة من الهامش إلى قلب الحياة اليومية، وأصبحت جزءاً من منظومة معيشية غير معلنة.
يشير عيسى آدم تاجر متضرر وفاعل مجتمعي إلى أن “ما يحدث الآن لا يمكن وصفه بسرقات عشوائية، نحن أمام شبكات تعرف ماذا تريد ومتى تتحرك وكيف تصرف المسروقات. فمن خلال الأسواق يمكن تتبع المسار بسهولة، بضائع تنهب من منازل أو مخازن، ثم تظهر بعد أيام في أماكن بيع معروفة، أحياناً بأسعار زهيدة تشير إلى أنها مسروقة، والجميع يعلم ذلك، لكن لا أحد يملك القدرة على الإبلاغ أو الاعتراض”.
وأضاف آدم، “قبل الحرب، كان الخوف من الشرطة والقانون يشكلان حاجزاً نفسياً، حتى على من يفكر في الجريمة. لكن اليوم اختفى هذا الحاجز تماماً. فالسارق لا يخشى البلاغ، لأنه يعلم أن البلاغ لن يسجل، أو لن يتابع أو لن يصل إلى نتيجة. بل إن بعض الضحايا باتوا يخشون التبليغ أكثر من الجريمة نفسها، خوفاً من الانتقام أو الوصم داخل الأحياء”.
وزاد “الأخطر أن هذه السرقات لم تعد تستهدف فقط الممتلكات، بل تهدد سبل العيش، إذ نجد متاجر تفرغ بالكامل ومخازن تنهب وورشاً تدمر، مما يدفع أصحابها إلى الخروج من السوق نهائياً. وبهذا المعنى، فإن الجريمة لا تسرق المال فحسب، بل تسرق الاستقرار، وتعمق الفقر، وتعيد إنتاج العنف بطريقة غير مباشرة”.
ورأى أنه “في بعض المناطق، أصبحت الجريمة جزءاً من دورة اقتصادية مشوهة. فهناك من يعيش على النهب ومن يشتري المسروق ومن يغض الطرف، إما خوفاً أو مصلحة. هذا التواطؤ الصامت لا يعبر عن عجز جماعي، فالناس تعلم أن ما يحدث، لكنها تشعر بأنها بلا خيارات”.
ومضى التاجر المتضرر في القول، “ما يقلقني كمواطن قبل أن أكون تاجراً، هو أن هذا النمط، إذا استمر، سيجعل من الصعب مستقبلاً إعادة بناء أي ثقة في السوق أو في المجتمع. فحين تصبح الجريمة وسيلة للعيش، لا تعود مجرد ظاهرة أمنية، بل تتحول إلى أزمة بنيوية تحتاج إلى معالجة سياسية واجتماعية، لا أمنية فقط”.
العدالة الشعبية
المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان أكرم حسن، يقول “في ظل انحسار دور مؤسسات العدالة في السودان، لم يعد اللجوء إلى القانون خياراً متاحاً لكثير من المواطنين، فبرز ما يعرف بالعدالة الشعبية كبديل اضطراري لردع الجريمة. غير أن هذا النمط من العقاب، الذي يأخذ أشكالاً عنيفة خارج إطار القانون، لا يعكس قوة المجتمع بقدر ما يكشف عمق هشاشته. وفي غياب الدولة، أصبح الشارع ساحة مفتوحة للفصل في الذنب والعقوبة، بلا ضمانات ولا معايير”.
وبين حسن أن “العدالة الشعبية التي نشهدها اليوم في البلاد ليست ظاهرة جديدة، لكنها بلغت مستوى غير مسبوق مع الحرب. فهي في جوهرها نتيجة مباشرة لانهيار منظومة القضاء والشرطة، وليست تعبيراً عن رغبة المجتمع في ممارسة العنف، إذ يلجأ إليها الناس لأنهم فقدوا الأمل في أن الجاني سيحاسب عبر الطرق القانونية”.
وتابع “المشكلة أن هذا النوع من العدالة يقوم على الاشتباه لا على الإثبات، وعلى الغضب لا على القانون. فالشخص الذي قد يتهم بالسرقة، يضرب أو يحتجز أو يقتل أحياناً من دون تحقيق أو محاكمة. ففي كثير من الحالات التي وثقناها، تبين لاحقاً أن الضحية لم تكن الجاني، لكن بعد فوات الأوان. هنا تتحول العدالة الشعبية من وسيلة ردع إلى أداة ظلم جديدة”.
وواصل “هذا النمط يفتح الباب لتصفية الحسابات الشخصية، أو استهداف الفئات الأضعف اجتماعياً، مثل النازحين أو العمالة الهشة أو الشباب العاطلين. وفي ظل الفوضى، يصبح الاتهام سلاحاً سهلاً، ويغيب أي تمييز بين الجريمة والفقر أو الاشتباه والانتماء الاجتماعي”.
ولفت الناشط في حقوق الإنسان إلى أن “العدالة الشعبية تقوض ما تبقى من فكرة الدولة، لأنها ترسخ منطق القوة بدل القانون. فكل حالة عقاب خارج إطار القضاء تعمق القطيعة بين المواطن ومفهوم العدالة المؤسساتية، وتجعل العودة إلى القانون أكثر صعوبة في المستقبل، بالتالي لا يمكن معالجة هذه الظاهرة فقط بإدانتها أخلاقياً. فالمطلوب الاعتراف بأننا أما أزمة أعمق تتمثل في غياب الدولة وانعدام الثقة، ومن دون إعادة بناء مؤسسات العدالة، ولو بصورة تدريجية، ستظل العدالة الشعبية حاضرة، لا لأنها صحيحة، بل لأنها الخيار الوحيد المتاح في نظر كثيرين”.
اختفاء القانون
في الفراغ الذي خلفه غياب مؤسسات الدولة، برزت قوى محلية تتولى مهام الأمن بصورة غير رسمية، من لجان حراسة شعبية إلى مجموعات مسلحة ذات نفوذ داخل الأحياء. هذه الكيانات، التي نشأت بدافع الحماية في ظاهرها، تحولت مع الوقت إلى سلطات أمر واقع، تفرض قواعدها الخاصة، وتعيد تعريف الأمن خارج إطار القانون.
هنا يقول سيد عثمان عضو لجنة حراسة شعبية “نحن لم نخرج لنلعب دور الدولة، لكن الواقع فرض علينا ذلك. فعندما توقفت الشرطة عن عملها، وبدأت السرقات تهدد البيوت ليلاً ونهاراً، لم يكن أمام الناس خيار سوى تنظيم أنفسهم. ففي البداية، كانت الفكرة بسيطة، نوبات حراسة وتنسيق بين الجيران ومحاولة ردع أي تحرك مريب. لكن مع مرور الوقت، تعقد المشهد وأصبحت السرقات أكثر جرأة، وباتت بعض العصابات مسلحة، بينما نحن مدنيون بلا حماية قانونية، مما خلق ضغطاً هائلاً على لجان الحراسة، وجعلها تتخذ قرارات لم تكن في الحسبان. فأحياناً يطلب منا احتجاز مشتبه فيه، أو تسليمه لمجموعة أخرى، لأنه لا توجد جهة رسمية يمكن الرجوع إليها”.
واستطرد عثمان “المعضلة الكبرى أننا نعمل في منطقة رمادية. فنحن لسنا مخولين بتنفيذ القانون، ولا نستطيع الانسحاب وترك الناس لمصيرهم. ومن ثَم فإن أي خطأ قد يحولنا من حماة إلى متهمين، وأي تهاون قد يعرض الحي للفوضى. فقد تنشأ سلطات غير معلنة قائمة على القوة والسمعة والخوف، لا على القانون”.
وزاد عضو لجنة الحراسة الشعبية، “نحن نعلم أن استمرار هذا الوضع خطر على المجتمع. فالأمن الذي يقوم على الأفراد لا يمكن أن يكون دائماً أو عادلاً. لكنه واقع موقت طال أكثر مما ينبغي. كثر داخل لجان الحراسة يتمنون عودة الشرطة والقضاء، لأن وجود الدولة، حتى بحدها الأدنى، يحمينا نحن أيضاً من الانزلاق إلى دور لا نريده. وفي النهاية، لا أحد يريد أن يحكم الشارع. فالناس تريد فقط أن تعيش من دون خوف. لكن طالما ظلت الدولة غائبة، ستظل سلطة الأمر الواقع هي البديل الوحيد، بكل ما تحمله من أخطار”.
اندبندنت عربية