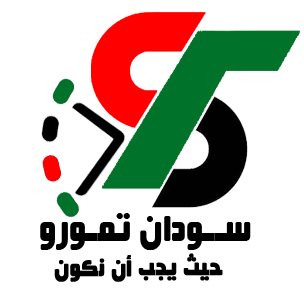سودان تمورو
يتغيّر العالم بوتيرةٍ غير مسبوقة، وبصورةٍ غير معهودة. هذه الحقيقة التي تجب مواجهتها الآن، مهما كانت قسوتها طاغية، وتأثيراتها حاكمة.
في المرحلة الحالية، يبدو النظام الدولي مناخاً أكثر منه مؤسسات ونظم قرارٍ وموجات أحداث متعددة المنشأ.
ففي علم الاجتماع السياسي، لا يُقاس النظام الدولي فقط بما يملكه من جيوش أو بما يفرضه من عقوبات، بل بما ينتجه من تصورات عن الإنسان، والشرعية، والمعنى. والنظام العالمي (كما يبدو الآن أكثر من أي وقتٍ مضى) ليس بنية تقنية محايدة، بل هو فضاء اجتماعي–رمزي يحدد من يُسمَع صوته، ومن تُحتسب معاناته، ومن يُعرَّف بوصفه “إنساناً كامل الصلاحية والحقوق” يستحق الحماية، ومن يُختزل إلى رقم في تقارير الخسائر، أو الأضرار الجانبية.
كم سمعنا هذه الكلمة؟ وكم كانت قاسية عندما تعلق الأمر بعزيزٍ أو بنظيرٍ في الخلق. من هذا المنطلق، يصبح ما يُسمّى بـ”نظام مجلس السلام العالمي” الذي يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم توسيعه في مناطق الأزمات والحروب، ليشكل بديلاً من منظومة الأمن الجماعي التي تشكلت بعد الحربين العالميتين، والقانون الدولي، وتقييد القوة. إن هذه المحاولة، تعني أكثر من إطار مؤسساتي، إنها محاولة تاريخية لإعادة تسييس الألم الإنساني ومنع تحويله إلى أداة حكم أو تأثير، أو صناعة مصير.
غير أن هذا النظام العالمي، الذي وُلد من رماد الكوارث الكبرى، يواجه اليوم أزمة بنيوية عميقة. فالنهج الذي مثّله دونالد ترامب والذي يكثّف محاولات عودة الإمبراطورية العارية، يقوم على تفكيك هذا الإرث، لا عبر نقده أو إصلاحه، بل عبر نزع شرعيته الأخلاقية والاجتماعية. في هذا النهج، تُختزل السياسة الدولية إلى معادلة بسيطة يقرر فيها من يملك القوة، بينما يقصى أو يتكيف من لا يملكها. وهنا، يصبح السؤال كبيراً بما يفوق القانون والديبلوماسية، ويطال الاجتماع والوجود الإنساني برمته.
ماذا يعني أن يُدار العالم بمنطق الأمر، لا بمنطق التوافق؟ وماذا يحدث للمجتمعات التي ترفض هذا الإخضاع؟
مصير الرافضين!
النظام الدولي الذي نشأ بعد الحربين العالميتين لم يكن مثالياً، ولا عادلاً في توزيع القوة أو الثروة، ثم إن خروج رئيس وزراء كندا في مؤتمر دافوس مؤخراً، معلناً بوضوح تام أن الدول الغربية سكتت على النظام السابق لأنه كان يخدمها، بينما كانت تعلم أنه ظالم ومتعدد المعايير، ويخدم الأقوياء فقط، هو اعتراف المضطر في سياق دفع خطر الشريك الذي ينوي افتراسه. إذاً هذا ليس اعتراف تائب يريد أن يعوّض فجوة الأخلاق التي دفعته إلى الاشتراك بنظام ظالم عن سبق إصرار وقصد.
لكن نظام ما بعد الحربين العالميتين من منظور الاجتماع السياسي، أدخل قيداً تاريخياً بالغ الأهمية، بتقييد العنف عبر المؤسسات، ولو ظاهرياً. لقد حوّل الحرب من ممارسة طبيعية للسيادة إلى استثناء يحتاج إلى تبرير، وأدخل مفاهيم مثل الجرائم الدولية، وحماية المدنيين، وحق الشعوب في تقرير مصيرها إلى المجال العام العالمي. وعلى الرغم من أن هذا التحول لم يلغِ الهيمنة، إلا أنه جعلها أكثر كلفةً من الناحية الرمزية، وأتاح للمجتمعات الضعيفة لغةً للاحتجاج والمطالبة.
أما ما يفعله النهج الإمبراطوري الجديد اليوم، فهو تحطيم هذه اللغة. حيث تُهمَّش المؤسسات الدولية، ويُسخَر من القانون الدولي، وتُدار العلاقات بين الدول بمنطق الصفقة والابتزاز، ثم إن المجتمعات التي ترفض هذا المسار تُعاقَب مادياً، وتُنزع عنها الشرعية الرمزية، لتُصوَّر بوصفها مشكلة، أو عقبة، أو كياناً غير متعاون. بما يحول السياسة إلى عملية وصم اجتماعي على نطاق عالمي.
وتلعب العقوبات الاقتصادية، في هذا السياق، دور أداة الضغط على النخب الحاكمة من جهة، وتقنية الحكم الاجتماعي التي تستهدف البنية اليومية للمجتمع من جهة أخرى. فهي تُضعف العملة، وتُفقر الطبقة الوسطى، وتُعيد توزيع الألم بطريقة غير متكافئة.
ومن المنظور السوسيولوجي نفسه، لا يعد هذا أثراً جانبياً، بل جزء من المنطق ذاته، الذي يعافي المجتمع كله بغرض إعادة تشكيل وعيه وسلوكه. والرسالة من ذلك تريد فرض قاعدة تقول إن الرفض مكلف، والطاعة أقل كلفة، حتى لو كانت مهينة.
لكن الأخطر من ذلك، هو أن هذا النهج يعيد تعريف الإنسان بوصفه وسيلة لا غاية. لأنه في النظام الإمبراطوري، لا تكون الكرامة متأصلة في كون الفرد إنساناً، بل مشروطة بموقعه السياسي. الإنسان الذي ينتمي إلى مجتمع مطيع يُنظر إليه بوصفه شريكاً في النظام العالمي. أما الإنسان الذي ينتمي إلى مجتمع رافض، فيُختزل إلى عبء، أو تهديد، أو رقم في إحصاءات الهجرة والفقر والضحايا، وهو في جميع هذه الأحوال أقل من أن يعتبر إنساناً كاملاً، وفق منظور الحاكم بالقوة. هكذا، تُفرَّغ الإنسانية من بعدها الكوني، وتُعاد قومنتها وتسييسها وفق مصالح القوة المهيمنة، وهو ما يصدّر سؤالاً مذهلاً: بما يفرق ذلك عن الفاشية؟
الآثار الاجتماعية المدمرة
إن لهذا التحول آثار مدمرة على النسيج الاجتماعي للدول المستهدفة. فالدولة، تحت ضغط العقوبات والتهديدات، تفقد قدرتها على أداء وظيفتها الأساسية المتمثلة بحماية المجتمع وتنظيم تضامنه الداخلي. ومع تراجع هذه القدرة، تنكسر العلاقة بين المواطن والمؤسسات. فالمواطن لا يعود يرى في الدولة إطاراً للعدالة أو الرعاية، بل جهازاً عاجزاً أو وسيطاً لإدارة الإملاءات الخارجية. وفي تلك اللحظة تحديداً، يبدأ المجتمع بالبحث عن بدائل طائفية، إثنية، جهوية، أو شعبوية راديكالية. ثم تستغل هذه الدينامية للقول إن الدولة لا تمتلك السيطرة الكافية على نفسها، ولا تؤدي أدوارها، وبالتالي وجبت “مساعدة شعبها” على التخلص من أشخاص الحكم، إذا لم يتخلصوا منهم هم بالانتخابات، وهذا يقود إلى الانقلاب تماماً على مبادئ الديموقراطية، التي كانت حتى الأمس القريب العنوان المفضّل لدى الدول الغربية في سعيها إلى الهيمنة على الموارد والإرادات.
وهنا تظهر مفارقة خطيرة تشير إلى أن النظام الإمبراطوري، الذي يدّعي الدفاع عن الاستقرار، بات يولد عملياً عدم استقرار اجتماعي عميق. لأن انعكاساته تُدمّر الطبقة الوسطى، وتُقوّض شبكات الأمان الاجتماعي، وتفقد الأمل بالمستقبل، ليصبح التطرف بكل أشكاله خياراً اجتماعياً مفهوماً، حتى لو كان مدمراً. وهذا لا يعني تبرير العنف، بل فهم جذوره السوسيولوجية، ونشأته من انسداد أفق السياسة، واختزال العالم إلى أوامر وعقوبات.
إن الشعوب الرافضة لنهج ترامب، أو لنهج الإمبراطورية عموماً، فهي لا ترفض فقط سياسة خارجية بعينها، بل ترفض إعادة تعريف العالم ضد ذاكرتها الجماعية. كثير من هذه المجتمعات تشكّل وعيها السياسي في ظل فكرة ولو جزئية أن النظام الدولي، برغم انحيازاته، يوفّر إطاراً للحماية، أو على الأقل للتفاوض. لكن هذا الإطار يُسحب الآن، ويُستبدل بمنطق “افعل أو عاقب”، وبذلك، يتحول الرفض إلى فعل هوياتي، وتعبير عن الهوية في مواجهة الخطر عليها، ويتمظهر ذلك بتعبيرات الرافضين ومسمياتهم للأشياء، كالدفاع عن الكرامة، وعن معنى الدولة، وعن فكرة أن المجتمع ليس مجرد سوق مفتوحة للإملاءات.
في هذا السياق، يجوز طرح سؤال: من يحمي الضعفاء؟ وهو سؤال قديم قدم الإنسان، لكنه اليوم متجدد. فالمؤسسات الدولية، التي أُنشئت نظرياً لهذه المهمة، تُفرَّغ من فعاليتها. والتحالفات التقليدية تُعاد صياغتها على أساس المصلحة الآنية، لا الالتزام الأخلاقي. وهكذا، يُدفَع الضعفاء إلى الاعتماد على أنفسهم، أو إلى البحث عن توازنات بديلة، غالباً ما تكون محفوفة بالمخاطر. اجتماعياً، هذا يعني انتقال العالم من منطق الحقوق إلى منطق الامتياز المشروط.
ولا يقتصر هذا التحول دول الجنوب العالمي. فحتى داخل المجتمعات الغربية نفسها، يُنتج النهج الإمبراطوري انقسامات حادة. هناك أيضاً تُقدَّم القوة بوصفها القيمة العليا، وتحتها تتآكل القيم الليبرالية التي تأسست عليها الدولة الحديثة، من التعددية، والضمانات الاجتماعية، إلى احترام القانون. المواطن في هذه المجتمعات أيضاً، يبدأ بالشعور بأن السياسة توقفت عن كونها تعبيراً عن الإرادة العامة، لتكون أداة لإدارة الهيمنة. وهكذا، تتلاقى أزمات الداخل والخارج في نقطة واحدة هي تفكك العقد الاجتماعي.
الجميع يمكن أن يكونوا ضحايا
من منظور اجتماعي–سياسي أعمق، ما نشهده اليوم هو صراع على تعريف الأمن ذاته. الأمن، في الرؤية الإمبراطورية، يعني السيطرة، والردع، وإخضاع الآخرين. أما الأمن، في الرؤية التي حاول نظام ما بعد الحربين العالميتين ترسيخها، فيعني تقليص أسباب الصراع، وبناء الاعتماد المتبادل، والاعتراف المتبادل بالكرامة. انتصار الرؤية الأولى، يعني تحويل العالم إلى فضاء خوف دائم، حيث تفسر إرادة الاستقلال كتمردٍ خطر يستوجب العقاب والإقصاء.
وفي مواجهة هذا الواقع، لا يمكن تقديم حلول تقنية سريعة، لكن يمكن تفسير خيارات وشرح مسارات ممكنة، منها أن القوة التي لا تُقيَّد تُنتج عالماً أقل إنسانية، حتى لمن يمارسها، وفي ذلك معطى تحفيزي للمجتمعات التي تخرج منها هذه المناهج التدميرية: بأنكم شركاء ليس فقط في الفعل الذي يقوم به صناع السياسة عندكم، بل أنتم شركاء في أن تكونوا ضحايا مع الآخرين. أما الشعوب الرافضة لنهج ترامب فهم فاعلون اجتماعيون يدافعون بوعي أو بحدس عن فكرة أن العالم لا يمكن أن يُدار إلى ما لا نهاية بمنطق الإمبراطور. رفضهم هو رفض لتحويل الإنسان إلى أداة، والمجتمع إلى ساحة اختبار.
المسألة إذاً أكبر من أن تكون مسألة سياسات أو زعماء، بل هي مسألة مصير مجتمعي عالمي. هل نقبل بعالم تُفرض فيه الأوامر بالقوة، وتُقاس فيه قيمة البشر بمدى طاعتهم؟ أم نصرّ برغم كل الاختلالات على عالم يعترف بأن كرامة الإنسان سابقة على القوة، وأن حماية الضعفاء ليست صدقة، بل شرط لبقاء أي نظام يدّعي أنه “عالمي”؟ هذا هو السؤال المركزي لعصرنا، والإجابة عنه تُحدَّد في قدرة المجتمعات على الدفاع عن إنسانيتها في وجه منطق الإمبراطورية، كائناً من كان حامله. بالأمس قادةٌ كثر تصدوا للأمر، اليوم ترامب، وغداً يوم آخر، وقادة آخرون.